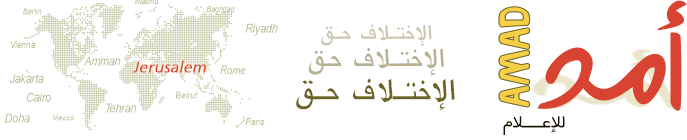أمد/
مدخل
سنتناول في هذه المقالة قصيدة “الغناء وريث الغناءْ” للشاعر صلاح أبو لاوي نموذجًا وندرسها معتقدين أنها قصيدة غنائيّة، ونتكئ عليها لدراسة قصائد أخرى باعتبار بعضها أيضًا قصائد غنائيّة. سنتناول مضمون القصيدة ونطرح خلفيّة فكريّة حول ماهيّة الشعر ومميزات الشعر الغنائيّ ونستخلصه من قصيدة “الغناء وريث الغناءْ”، ونفحص وجوده في قصائد أخرى، سنركّز على التقنيّات الفنيّة المختلفة في القصيدة، مثل: التكرار بأنواعه، والسؤال البلاغيّ والمجاز والثنائيّات الضديّة وغيرها وهي أمور تفيد تماسك القصيدة ممّا يُثريها بالدراميّة الضروريّة لجذب المتلَقّي لتشويقه وإثارته ولتحقيق متعته.
“الغناء وريث الغناءْ” هي قصيدة ذاتيّة-غنائيّة من الشعر التفعيليّ نُظمت على تفعيلة بحر المتدارك – فاعلن/ فَعِلُنْ مبنى دائريّ يفتتحها الشاعر بـ “الغناءُ وريث الغناءْ” (كعنوان) وينهيها بنفس الجُمْلَة، يسمّى هذا الأسلوب عند البعض “الدائرة المغلقة” وكأنّ الشاعر يريد حماية موضوع القصيدة بإغلاقها. هنالك إمكانيّتا تفسير: الأولى هي أنّ القصيدة لم تنتهِ، وعمليًّا ربّما تعود وتتكرّر الحالة. والثانية في هذا المبنى نلحظ انعدام المخرج من الحالة الشعريّة وربما اختناقا. هكذا يترك الشاعر للمتلقّي القرار ووضع خاتمة تناسبه. ومرة أخرى تتكرر جُملة “الغناء وريث الغناءْ” في وسط القصيدة لتفصل بين ما قبلها في القسم الأول الذي يوجه حديثه بشكل عام وبين ما بعدها الذي يوجه حديثه فيه بشكل خاص إلى الأنا.
يطرح الشاعر في قصيدته بضمير المتكلم تساؤلاته حول ماهيّة الشعر، وحول دور الشاعر، وحول ذاته: من أكون وما هو دوري؟
يقول الشاعر الإنجليزي جون كيتس (John Keats):
“إن لم يأتِ الشِّعرُ بشكل طبيعيّ مثلما تظهر الأوراقُ على الأشجار، فالأفضل ألّا يأتي إطلاقًا”.
فهل ينطبق هذا على شعر صلاح أبو لاوي؟ هل يُشعرك بالسّلاسة، بالعفويّة، بالصّدق وبتلقائيّة ما يصفه؟ هل ما يتكلّم عنه يصل سريعًا إلى قلب المتلقي، ويثير تفكيره ووجدانه.
الشاعرةُ الأمريكيةُ أميلي دِكنسُن Emily Dickinson:
إذا قرأتُ كتابًا وأحسستُ بقشعريرة لا يُمكن حيالها لأي نار أن تبعث الدفء في جسدي، عرَفتُ عندها أنني إنما أقرأ شعرًا. وإذا شعرت كما لو أنَّ قمة رأسي لم تعد في مكانها، أدركت أنَّ ذلك هو الشعر. هذان هما سبيلاي لمعرفة الشعر، فهل ثمة سبيل آخر؟
مضمون القصيدة: الشعر واللا شعر
في القصيدة تلميح واضح لقصيدة المتنبي: وَاحَـرّ قَلْبـاه
المتنبِّي شاعرِ العَرَب، ومالئ الدُّنيا وشاغل الناس وكان ذا كبرياء وشجاعة وطموح ومُحبًّا للمغامرات، وكان في شعره يعتزُّ بعروبته، ويفتخرُ بنفسه، وأفضلُ شعرهِ في الحكمة وفلسفة الحياة ووصف المعارك، إذ جاء بصياغة قوية مُحكَمة. وكان شاعرًا مُبدعًا مُحلِّقًا غزيرَ الإنتاج، ولا يقوم شعرُه على الصَّنعة والتكلُّف، لتفجُّرِ أحاسيسِه وامتلاكه ناصية اللغة والبيان، ممَّا أضفى عليه لونًا من الجمال والعذوبة. ترك تراثًا عظيمًا من الشعر القويِّ الواضح. (الويكيبيديا).
كيف يبرز هذا في قصيدة “الغناء وريث الغناءْ”/ صلاح أبو لاوي؟ أمثلة:
شاعرٌ لا يجيد الغناءْ = هناك من يكتب نصوصًا ويسمونه شاعرًا ولكنّه لا يجيد كتابة الشعر.
لا وريث أبي كنتُ قبل المجازِ= مِن أنايَ أتيتُ: لم أرث الشعر من والدي.
مِن أنايَ أتيتُ وأمضي بلا قلقٍ لأنايْ= شعري من ذاتي وأنا لست قلقًا.
النجوم مصابيح روحي، وزوادتي -هوايْ: النجوم وحبي والنور هم مصدر روحي وأُم شعري.
صاعدًا صاعدًا أتشبثُ بالحلمِ حتى تصير المجراتُ بعضَ رؤايْ=كتابة الشعر هي صعود إلى المجرّات والتي هي رؤياي/حلمي
وعبادي الفراشاتُ والعاشقاتُ شذايْ =تصالب: الفراشات والعاشقات هي مصدر شعري.
ولا فرسي ببّغايْ: روحي مصدر شعري لستُ كالببغاء، لا أقلّد ولا أنقل عن خارج روحي.
مَنْ سوايَ يقودُ إليّ سوايْ……………….. الغناء وريث الغناء=أنا من يقود شعري، لا أحد غيري. سيذكرونني نبيًا، الغناء وريث الغناء= الشعر هو الشعر. الشعر يتفجّر مني كبركان.
أأنا المتنبي أم المتنبي أنا =من أنا؟ هل أنا المتنبي؟ هل المتنبي أنا؟ = يعتز الشاعر أبو لاوي بنفسه مثلما فعل المتنبي القائل:
سَيعْلَمُ الجَمعُ مـمّنْ ضَـمّ مَجلِسُنـا // بأنّني خَيـرُ مَنْ تَسْعَـى بـهِ قَـدَمُ
أنَا الذي نَظَـرَ الأعْمَـى إلى أدَبـي // وَأسْمَعَتْ كَلِماتـي مَنْ بـهِ صَمَـمُ
أنَامُ مِلْءَ جُفُونـي عَـنْ شَوَارِدِهَـا // وَيَسْهَـرُ الخَلْـقُ جَرّاهَـا وَيخْتَصِـمُ
أيها الشعراءْ اذكروا جيدًا “الغناء وريث الغناءْ” كنت وحدي وكانت سمائي معلقةً بين أنشوطتينْ:
كم تَطْلُبُونَ لَنَـا عَيْبـاً فيُعجِزُكـمْ // وَيَكْـرَهُ الله مـا تَأتُـونَ وَالكَـرَمُ
ما أبعدَ العَيبَ والنّقصانَ منْ شَرَفِـي // أنَـا الثّرَيّـا وَذانِ الشّيـبُ وَالهَـرَمُ
لَيْتَ الغَمَامَ الذي عنـدي صَواعِقُـهُ // يُزيلُهُـنّ إلـى مَـنْ عِنْـدَهُ الدِّيَـمُ
أرَى النّـوَى يَقتَضينـي كلَّ مَرْحَلَـةٍ // لا تَسْتَقِـلّ بِهَـا الوَخّـادَةُ الرُّسُـمُ
الشعر الغنائي Lyric poetry
الشعر يعني أن تسمع صوت الحالة بالأحرف، إن قلت ماءً أسمع خريرًا، وإن قلت اختناقًا أسمع قعقعة، إن تكتب عن أحاسيسك، أسمع إيقاعات قلبك، في الشعر أسمع أنينًا في الحزن، وأسمع تصفيقًا عند الفرح، الشعر أن تثير تعابيرك تداعيًا للأفكار، الشعر أن تكتب قليلًا وتثير أفكارًا كثيرة، أن تفاجئني وتدهشني التعابير.
الشعر الغنائيّ هو نوع أدبيّ يتميز بالتعبير عن الأحاسيس والإفصاح عنها. وُلِد الشعر الغنائيّ بين القرنين السابع والسادس قبل الميلاد في اليونان. أصل الاسم من الآلة الموسيقيّة التي رافقت الشعراء في تلك الفترة عند إلقاء قصائدهم، وهي ما يسمى (lyre) وهي آلة موسيقيّة شبيهه بالقيثارة الصغيرة.
أحيانًا كان إلقاء القصائد مصحوبًا بالرقص أو بالجوقة. يُعَبِّر الشعر الغنائيّ عن عاطفة أو عن لحظة عابرة من وجهة نظر شخصيّة للفرد، وهذا تناقض كامل مع أعراف وتقاليد الشعر الملحميّ، الذي كان سائدًا في نفس الزمان والمكان. لقد كُتبت الأعمال لعرضها لمرة واحدة أمام جمهور محدّد في حدث محدّد، وكان الشاعر المتكلم في القصيدة، “الأنا”، يُنظَر إليه كقناع يرتديه الشاعر، وليس تمثيلًا حقيقيًا له ولمشاعره: فالشاعر يُعير شخصه من أجل التعبير عن الأمور، مما يؤدي إلى إنتاج تجسيدًا لتجربة شخصية أو عاطفة ذاتيًة والتي تكون إنسانيّة عالميّة بطبيعتها. يُكتب هذا النوع غالبًا بضمير المتكلم.
القصيدة الغنائيّة ذاتيّة، تحمل المشاعر الشخصيّة للمؤلف، الذي يُنشد عن نفسه، وعن موقفه تجاه الطبيعة، وتجاه الآخرين والحياة. يتم التعبير عن المشاعر من خلال وسائل فنيّة، مثل: تشبيهات واستعارات وصور لغويّة وغيرها، وتصبح كل هذه مشاعر إنسانيّة عامّة وموضوعيّة فوق المشاعر الشخصيّة. القصيدة الغنائيّة بَعْد – زمنيّة، على الرغم من أن الأزمنة في القصيدة قد تتغير، مثلًا: قصائد الحب والوحدة والعزلة، والجمال والأشواق، والسعادة، والصلاة والموت، والغيرة والحسد والإعجاب.
تتميز القصيدة الغنائيّة بخصائص تميّزها عن أنواع القصائد الأخرى، مثل: العواطف والمشاعر، وضمير المتكلم –أنا، والقصيدة موسيقيّة جدًا، وتحدث في زمن الحاضر وفي الأزمنة القريبة منه، والشعر الغنائيّ عالميّ ودائمًا ما يكون ذا صلة مع أحداث الساعة، في القصيدة الغنائيّة نجد إسقاطا، بمعنى أنه توجد أهميّة كبيرة للمناظر الطبيعيّة وأمور أخرى تكون ذات معنى هام.
يقول د. محمد عبيدالله: “الروح التي تتأسس عليها القصيدة الغنائية معظم سماتها تنبع من تلك الذاتية وتترجمها على نحو أمين، من خلال ارتكازها غالبًا على ضمير المتكلم المفرد، فهو الضمير الذي يقابلنا في معظم القصائد الغنائية، وهو يعبر مباشرة عن صوت الشاعر الذي يتكلم بلسانه ويعبر عن ذاته، كما لو كان لا يتوجه إلى أحد في خطابه، إنه حسب تعبير إليوت: “صوت الشاعر مخاطبا نفسه، أو غير موجه كلامه إلى أحد” (موقع الجزيرة، 10.2.2025).
غنائية قصيدة الشاعر صلاح أبو لاوي “الغناء وريث الغناءْ”
التكرار: تمتاز قصيدة “الغناء وريث الغناءْ” (وقصائد أخرى عند الشاعر) بالتكرار كأسلوب تعبيريٍّ غنائي ولإبراز مضمون القصيدة المذكورة: الشعر والّلا شعر من ناحية ومكانة أنا الشاعر من الناحية الأخرى وتأكيده، ولزيادة الترغيب في التعامل معها، ولاستمالة المتلقي، ولتناسق الكلام، وجعله أكثر إيقاعًا، وللحثّ، ولإثارة الأحاسيس في نفسه، ويحدث ذلك بذكر الجملة مرّتين أو ثلاث مرّات، أو بتكرار الكلمة الواحدة.
التكرار لا يقوم فقط على مجرّد تكرار اللَّفظة في السياق، وإنّما ما تتركه هذه اللَّفظة من أثر انفعاليٍّ في نفس المتلقّي، وبذلك يعكس جانبًا منَ الموقف النفسيّ والانفعاليّ، ومثل هذا الجانب لا يمكن فهمه إلّا من خلال دراسة التكرار الّذي يمثّل إحدى الأدوات الجماليّة الّتي تساعد على فهم مشهد، صورة، أو موقف ما، إنّه يعكس الأهميّة الّتي يوليها المتكلّم لمضمون الجمل والتعابير واللّفظات المكرّرة، باعتبارها مفتاحًا لفهم المضمون العامّ الّذي يتوخّاه المتكلّم. إضافة إلى ما تحقّقه من توازن هندسيٍّ وعاطفيٍّ بين الكلام ومعناه (طنوس، 2022. ص 30). ونطرح بعض الأمثلة:
تكرار الأحرف الحاء 14 مرة، الهمزة (61) مرّة، والهاء (15) مرّة. ما معنى هذا؟
يقول “ابن منظور” عن خواص حرف الحاء: بارد رطب وله طبع الماء، وفي القصيدة نجد الكلمات: يحاصر (4)، حتى، حلم، حالم، أحد، وحدي، نوح، الحالتين والرياح وهي كلمات تتماثل مع قول ابن منظور. والهمزة (61) مرّة، والهاء (15) مرّة، وهذه الأحرف الثلاثة تشكّل داعمًا لبعضها البعض. هي أحرف فيها محاكاة لأحاسيس الشاعر، وهي أصوات تخرج من صدره ونسمع في لفظها الآهات والأنين، والتأوُّه والحنين.
تكرار حرف الدال (26). هو أحد أحرف “ق. ط. ب. ج. د” وهي أحرف تشير إلى الحركة والاضطراب، خاصة في صوت الحرف الساكن من مخرجه ليظهر ظهورًا كاملًا للدلالة على الحزم والقوة، وهما صفتان تميزان الشاعر في قصيدته “الغناء وريث الغناءْ”. كقول أبي تمام في مدح المعتصم: السيف أصدق إناءً من الكتب// في حدّه الحدّ بين الجدّ والّلعب. (طنوس، 2022. ص271)
تكرار توكيدي: Epizeuxis)): التكرار التوكيديّ في البلاغة هو تكرار كلمة أو عبارة في تتابع فوري، عادة داخل نفس الجملة للتقوية والتوكيد (وهبة والمهندس، 1984، ص117).
صاعداً صاعداً، بعدَ بَعْدي، بينَ بينٍ وبينْ بين، عينٍ وعين. (قصيدة “الغناء وريث الغناءْ”)
يكثر استثمار التكرار التوكيديّ عند الشاعر في قصائد أخرى، مثل:
في كتاب “يدور الكلام تعالى”، 2013: الغيمة الغيمة (ص 23)، حبّة حبّة (33)، ونحن نكاد نكاد (ص 44) نشيدًا نشيدً، رويدًا رويدًا (ص 45)، خيول خيول (ص 49 مرتين).
في كتاب “تبلو”،2014: ما فات فات (ص 19)، عين عيني (ص 26) وغيرها.
في كتاب “فعله صغيرهم هذا عنان”، 2022: القليل القليل (ص 50)، واحدًا واحدًا (ص 54)، بيروت بيروت (ص63)، يا أبي-يا أبي (ص 70).
تكرار الصدارة: Anaphora)) في البلاغة أداة بلاغيّة تتكون من تكرار سلسلة من الكلمات في بدايات أشطر القصيدة المجاورة والمتتاليّة للتركيز عليها (وهبة والمهندس، 1984، ص117). أمثلة:
“مَنْ يحاصر هذا المدى!
منْ يحاصر سرب سنونو له كلّ هذا الفضاءْ!
منْ يحاصر فيّ السّماءْ” (قصيدة “الغناء وريث الغناءْ”)
في كتاب “يدور الكلام تعالى”، 2013: كلمة الفكرة في سطرين متتاليين (ص 20)، كلمة الوقار (ص 21)، كلمة أول (ص 44. أربع مرات)، كلمة تدور (ص45 و56)
في كتاب “تبلو”، 2014: العصافير (ص 14)، اخرجي (ص 20)، لم أجئ (ص 21) وغيرها.
في كتاب “فعله صغيرهم هذا عنان”، 2022: كوني ثلاث مرات (ص 13)، ربما خمس مرات (ص 18)، اعذريني ثلاث مرات (ص 19)، الليالي سبع مرات (ص 31) وغيرها الكثير.
الربط أو الإلحاقConcatenation) ): وسيلة فنيّة في الشعر وهي عبارة تكرار كلمة في بداية سطر معين لنفس الكلمة في نهاية السطر الذي يسبقه ( أوخماني ب. ص 288):
“يستعير الندى
والندى
فمن سأكون أنا
أأنا”
“بينَ بينٍ وبينْ
بين” (قصيدة “الغناء وريث الغناءْ”)
في كتاب “يدور الكلام تعالى”، 2013: المدى والسطر الذي يليها المدى (ص51) أمشي والسطر الذي يليها وتمشي (ص 98) وغيرها.
في كتاب “فعله صغيرهم هذا عنان”، 2022: لهفته للقرى-والقرى (ص45)، عطشى-وعطشى (ص 48)، الغمام-الغمام، الهيام-الهيام-(ص114)
السؤال البلاغيّ / الإنكاريّ
هو أن يخرج الاستفهام عن معناه ليصبح هدفه إنكار الشيء المستفهم عنه، ولا يقتصر خروج الاستفهام عن معناه الحقيقيّ على معنى الإنكار فقط، بل أيضَا توجد معانٍ أخرى، مثل: التهويل والتعظيم، التشويق، التمنّي والتقرير والاستبطاء والفخر والتحسّر والتوجّع، وما إلى ذلك من أغراضٍ أخرى.
“مّنْ يحاصرُ مَنْ؟
مَنْ أنا؟
منْ يحاصر سرب سنونو له كلّ هذا الفضاءْ!”
“فمن سأكون أنا
أأنا المتنبي أم المتنبي أنا
أمْ أنا لا أحدْ” (قصيدة “الغناء وريث الغناءْ”)
في كتاب “يدور الكلام تعالى”، 2013: يا موت مالي ومالك (ص 11)، تكمن فينا أم في الحاكم أم تكمن في الأوطان العلّة (ص 25)، جراحكم أن قلوبَنا عَرَجَتْ إليك-وقد رأتك غمامها- جرحى (ص 55)، يا أمّنا الصّحراءَ كم سنة ستحتاج الورود لكي تعود إلى نضارتها؟ (ص 97).
في كتاب “فعله صغيرهم هذا عنان”، 2022: لماذا أحنّط موتي وأرسله خلفكم. هل خانني الناس أم خنتهم (ص 68)
الجِنَاس
الجِنَاس لغويًّا هو: تشابه لفظين في الحروف مع اختلافهما في المعنى، وهو يعتبر من المحسنات اللفظيّة ووظيفته إضفاء لمسة جماليّة على اللّفظ وإحداث نغم موسيقيّ وتوضيح المعنى وتقويته وتأكيده في ذهن المتلقّي، أمثلة:
الهواء-الهوى، الندى-المدى (قصيدة “الغناء وريث الغناءْ”)
في كتاب “يدور الكلام تعالى”، 2013: حبّةً-حُبًا (ص 33)، جهارًا-نهارًا (ص 37)، الدهر-القهر (ص 59)، جنون-فنون (ص 78) وغيرها.
ثنائيات ضديّة:
الثنائيّة الضديّة موجودة بكثرة في الإبداع الأدبيّ، خاصّة الشعر منه، والّذي يحتوي في جوهره على عوامل التضادّ ممّا يؤدّي إلى المفاجأة والتوتّر والعودة إلى التأمّل بحثًا عن ماهيّة الأمور، والسؤال الّذي يتبادر إلى أذهاننا، أحيانًا: كيف علينا التعامل معه؟
ثنائيّات أيّ أديب خاصّة به، وجاءت من عالمه، وهو يقدّم بها رؤيته للإبداع والحياة والوجود بطريقته هو، وربّما، أحيانًا، تتماثل مع ثنائيّات أديب آخر، أمثلة: أتيت-أمضي، أأنا عابرٌ أمْ مقيمٌ، فلتعشْ أيها الموتُ، أطفأ-اشتعل، فلتعشْ أيها الموت (قصيدة “الغناء وريث الغناءْ”).
في كتاب يدور الكلام تعالى، 2013: ذهبوا-يرجعون (ص 17، 18)، القصير-الطويل (ص 65).
في كتاب “تُبِلو”، 2014: الكاسيات-العاريات، يكبرون – لا يهرمون (ص 15)، البداية-النهاية (ص 18)
في كتاب “فعله صغيرهم هذا عنان”، 2022: يحلم بالورد والبندقيّة (ص76)، الليل-النهار (ص78)، أعد ميتًا للحياة (ص 79)
تصالب Chiasmus:
شكل فني في الشعر وهو عبارة مقابلة متصالبة في جملتين. يكون مبنى الجملة الثانية معاكس للجملة الأولى على شكل x يفيد هذا المبنى إبراز التناقض، أمثلة:
“وعبادي الفراشاتُ والزهرُ
والعاشقاتُ شذايْ” الضلع الأول مكوّن من “عبادي مع شذاي” وهذا يتصالب مع الضلع الثاني المكون من “الفراشات والزهر مع والعاشقات”(قصيدة “الغناء وريث الغناءْ”)
في كتاب “يدور الكلام تعالى”، 2013: “أميل شمالًا- يمينًا أميل” (ص13)، “للحرب مقعد- ومقعد لمن يصاحب الغزاة”(ص 19)، “جموع تروح- وتأتي جموع” (ص 50) وغيرها.
في كتاب “فعله صغيرهم هذا عنان”، 2022: ما هناك هنا-وما هنا هناك (ص53-54)
الجريان/ التضمين: Enjambment:
الجريان/التضمين هو عدم إتمام المعنى في بيت واحد، وإنما يتمّ المعنى في أكثر من بيت/سطر، هذه الخاصّية تعطي جريانًا في نمو الحدث والمأساة والتشويق، وربط الأحداث في جو القصيدة، وتصاعد متدفّق للحدث؛ الأمر الذي يزيدنا تلهّفًا وتشوّقًا.
“والهوى قمرٌ ثَملٌ
يستعير الندى
أتشبثُ بالحلمِ
حتى تصير” “(قصيدة “الغناء وريث الغناءْ”)
في كتاب “يدور الكلام تعالى”، 2013: السطر الأول “حين يعدو بها الحلم” يتم المعنى في السطر الثاني “يرتبك النجم” (ص 49)، السطر الأول “أنا عبد الرصاصة” يتم المعنى في السطر الذي يليه “لم أكن عبدًا” وغيرها.
في كتاب “تبلو”، 2014: “ثلاثة أسطر ليتم المعنى: الأول “يا إله السماوات”، الثاني “يَسَّرتها لسوانا” السطر الثالث “وأسكنتنا في الجحيم ليوم الحساب”.
في كتاب “فَعَلَه صغيرُهم هذا عنان”، 2022: السطر الأول “لم أملك من هذي الدنيا” يتم المعنى في السطر الذي يليه “إلّا الشعر ونفسي”، “وفوضى تعمُّ السحائب” ويتم المعنى في السطر الذي يليه “لا شيء يبقى”.
تكرار جملة -لازمة:
الّلّازمة قد تكون مفتاحًا لإبراز النقطة المركزّية في القصيدة. تزيد من الحركة والإيقاع اللذان يفيدان المضمون: “الغناءُ وريث الغناءْ ثلاث مرات. تتناغم مع: “الهواءُ شريك الهواءْ” (قصيدة “الغناء وريث الغناءْ”)
في كتاب “يدور الكلام تعالى”، 2013: حين تصحو (ص15-16)، لوكان لي (94-95)، يا أمّنا الصحراء (ص97)، لك القلب وهي الشام (ص 109-112) وغيرها.
في كتاب “تُبِلو”، 2014: كنت وحدي (ص 23،25،26)
في كتاب “فعله صغيرهم هذا عنان”، 2022: تنفس (ص 72-77)، أريد أبي (ص 78-82). “آخر الليل” هي مطولة من خمسين صفحة ومركبة من 46 مقطعًا، “آخر الليل” هو عنوان المطولة وهو بمثابة لازمة وعتبة لدخولها ويؤكد هذا العنوان بزوغ الفجر وزوال الاحتلال.
المجاز:
هو الابتعاد عن المعنى الظاهر والذهاب إلى معنى مقترن به. أي أنّ اللّفظ يُقصد به غير معناه الحرفيّ، بل معنى له علاقة غير مباشرة بالمعنى الحرفيّ. والمجاز من الوسائل البلاغيّة التي تكثر في الشعر إذ يعطي الشاعر انزياحًا عن المعنى المقصود ممّا يتطلّب من المتلقّي التفكير بما يقصده الشاعر، وهو يستطيع ذلك من سياق القصيدة ومن الحالات المختلفة فيها ومن بعض الرموز التي تشير إلى حقائق معيّنة، فالاستعارة بكلّ أنواعها والكناية هي في هذا المجال. أمثلة: والهوى قمرٌ ثَملٌ، النجوم مصابيح، وزوادتي للطريقِ هوايْ، أتفجّرُ شعرًا (قصيدة “الغناء وريث الغناءْ”).
في كتاب “يدور الكلام تعالى”، 2013: الكلام المقطّرُ، الزمان البخيل، قاع المدينة جدّي أمّي عُشّي، كبد الضوء، الوقار الغبيّ، الطرقات تنزفني وغيرها.
في كتاب “تُبِلو”، 2014: مدينة حُلمٍ تنام على كفِّ ماء، فرسٌ ثملٌ أشقر، سأفرش غابات مائي لعينيك، لمن أرضعته الزوابع حسرتها وغيرها.
في كتاب “فَعَلَه صغيرُهم هذا عنان”، 2022: البحيرات أثداء هذي الطبيعة (ص9)، أنا حبة قمح (ص 15)، أرواحنا شرر والحياة دخان (ص 69)، بيروت سرُّ البحر(62)، الحديقة ساذجة كالحكايات (ص 67) وغيرها
خاتمة
قصيدة “الغناء وريث الغناءْ” متكاملة فنًا ومضمونًا، ومفعمة بالأحاسيس، ولغتها سلسة، وإيقاعاتها وموسيقاها تثير المتلقي لإنشادها. تحكي القصيدة تأملات وتساؤلات: مَنْ يحاصر (أربع مرات)، أأنا المتنبي أم المتنبي أنا? أمْ أنا لا أحدْ? تشير إلى حيرة واضطراب وضجيج وتدور هذه التأملات والتساؤلات إلى أن يفيض نور الشاعر ويؤدي إلى صحوته فيضيء قلبه وينفجر شعرًا وفي النهاية يهون في قلبه العذاب. ويمضي بلا قلقٍ إلى ذاته وتصبح النجوم مصابيح روحه الطليقِ وزوادته للطريقِ هواه. مبنى القصيدة الفني دائريّ بحيث يتماثل هذا المبنى مع المضمون.
خلال دراستنا لشعر الشاعر وتعاملنا مع قصيدة “الغناء وريث الغناءْ” نموذجًا لشعره، اعتمدنا عليها ووجدنا أن شعره يميل كثيرًا إلى الغنائيّة وبعض قصائده غنائية دراميّة، خاصة قصيدة “فَعَلَهُ صغيرُهمْ هذا عنان”. التي تتمحور حول شخصية مختارة لها علاقة متينة بالواقع الفلسطيني والحياة الفلسطينية، فعنان قد كيون كل واحد منّا، كأن يكون مقاومًا أو شهيدا أو أي طفل جَابَهَ دبابة، وقد يكون أي إنسان يقوم بواجبه الوطني: اب، أم، معلم، تاجر، عام، موظف، رئيس والأهم أن يقوم بواجبه وكما يقول برتولد برغت في قصيدته “خذ زمام الأمور: تَعَلَّم ابسط شيء، لم يَفُت الأوان على الذين دنت ساعتهم، تَعَلَّم أحرف الهجاء، هي لا تكفي، ولكن تَعَلّمها، لا تتذمر، افتح الكتاب، عليك أن تعرف، كل شيء وأن تأخذ زمام الأمور، تَعَلَّم يا من في الملاجئ تسكن! تَعَلَّم يا من في السجون تقبع! تَعَلَّمي يا امرأة في المطبخ! تَعَلَّمي يا امرأة في الستين! خذي زمام الأمور، اذهب إلى المدرسة، يا من لا بيت له، اكتسب المعرفة، أيها المتجمد بردًا، أيها الجائع، مد يدك إلى الكتاب فانه سلاح. عليك أن تأخذ زمام الأمور، يا صاحبي، اسأل، ولا تخجل، ولا تّغُرَّنَكَ الثرثرة، ابحث أنت! ما لا تكتشفه بنفسك لن تعرفه، افحص الحساب، يجب أن تدفع، أشر إلى كل شيء، واسأل: من أين جاء هذا إلى هنا؟ عليك أن تأخذ زمام الأمور”.
هكذا نجح صلاح أبو لاوي في إبداعه قصيدة غنائية درامية برفع شخصيات عادية واقعية إلى مستوى الرمز والأسطورة، فعل ذلك في شخصية “عنان” حين جعل منها رمزًا فلسطينيًا في أن يكون الفرد منتميًا بكل جوارحه لفلسطين على أمل التحرر والعودة.
وعنان كما قال غسان إسماعيل عبد الخالق: “عنان هو الاسم الشعري لصلاح أبو لاوي” (موقع الدستور 12.7.2022). ونؤيد ما قال الكاتب رشاد أبو شاور عن الشاعر صلاح أبو لاوي: “هو كشاعر يمكن أن يوصف بأنه شاعر مقاوم، منحاز، منتم، وهذه الصفات تجعله شاعر غضب (رشاد أبو شاور، 16.2.2024)
المصادر
أبو شاور، رشاد. (2024). صلاح أبو لاوي شاعر مقاوم. موقع الميادين 16.2.2024. https://www.almayadeen.net/arts-culture/%D8%B5%D9%84 –
أبو لاوي، صلاح. (2013). يدور الكلام تعالى. إصدار بيت الشعر الفلسطيني. وزارة الثقافة.
أبو لاوي، صلاح. (2014). تُبلو. منشورات رابطة الكتاب الأردنيين.
أبو لاوي، صلاح. (2022). “فَعَلَه صغيرُهم هذا عنان”. إصدار الفينيق. عمان.
عزرائيل، أوخماني. (1979). معجم المصطلحات الأدبية. إصدار سفريات بوعاليم. تل ابيب.
طنوس، نبيل. (2022). اختراق النصّ الأدبي. سهيل عيساوي للطباعة والنشر. كفر مندا.
عبيد الله، محمد. (2025). جدل الغنائية والدرامية في نماذج من الشعر الفلسطيني الحديث. موقع الجزيرة 10.2.2025. https://aja.ws/qg2sq9.
مجدي وهبة وكامل المهندس. (1984). معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مكتبة لبنان ناشرون. بيروت.
**
صلاح أبو لاوي
شاعر فلسطيني مقيم في الأردن. عضو رابطة الكتاب الأردنيين والاتحاد العام للأدباء العرب. شارك في العديد من المهرجانات والأمسيات الشعريّة في الأردن وعدد من الدول العربية. صدر للشاعر:
ليتني بين يديك حجر (1988).
الغيم يرسم سيرتي (2008).
إني أرى شجرًا (2010).
يدور الكلام تعالى (2013).
تُبَلو(2014).
فَعَلَهُ صغيرُهم هذا عنان (2022).
الغناء وريث الغناءْ/ صلاح أبو لاوي
الهواءُ شريك الهواءْ
والهوى قمرٌ ثَملٌ
يستعير الندى
والندى
شاعرٌ لا يجيد الغناءْ
مَنْ يحاصر هذا المدى!
منْ يحاصر سرب سنونو له كلّ هذا الفضاءْ!
منْ يحاصر فيّ السّماءْ
لا وريث أبي كنتُ قبل المجازِ
ولا فرسي ببّغايْ
مِن أنايَ أتيتُ
وأمضي بلا قلقٍ لأنايْ
النجوم مصابيح روحي الطليقِ
وزوادتي للطريقِ هوايْ
صاعداً صاعداً
أتشبثُ بالحلمِ
حتى تصير المجراتُ بعضَ رؤايْ
حالمٌ
كإلهٍ قديم المنى
وعبادي الفراشاتُ والزهرُ
والعاشقاتُ شذايْ
مَنْ سوايَ يقودُ إليّ سوايْ
بعدَ بَعْدي
سيذكرني الآخرون
كما يذكر الأشقياء نبيّاً مضى
ويعيدون ترتيب هذا الفضاء كما شئتهُ
ويقولون كان الفتى
مّنْ يحاصرُ مَنْ؟
والزّمنْ
لعبة الشعراءْ
فاذكروا جيّداً
الغناءُ وريث الغناءْ
أتفجّرُ شعراً
فمن سأكون أنا
أأنا المتنبي أم المتنبي أنا
أمْ أنا لا أحدْ
زَبَدٌ في الزّبدْ
يتلاشى مع النّوحِ
أمْ أتجددُ في ذكريات الأبدْ
أأنا عابرٌ أمْ مقيمٌ
ومن سوف يعتمدُ الضّوء إذْ يُعتمدْ
كلُّ ما قلتهُ
قاله الناسُ قبلي
فلستُ أضيفُ إلى كلّ هذا البددْ
مَنْ أنا؟
فلتعشْ أيها الموتُ
حتى أطلّ على صورتي
وأرى ما نسيتُ
وما نسيَ الأنبياءْ
أيها الشعراءْ
اذكروا جيدأ
الغناء وريث الغناءْ
كنت وحدي
وكانت سمائي معلقةً بين أنشوطتينْ
بينَ بينٍ وبينْ
بين ما كان أو سيكونُ
وما بين عينٍ وعينْ
والذي أطفأتهُ الرياحُ
سيشتعل اليومَ في صورتينْ
صورتي في المرايا
وصورة جدّي الذي تاه في الزّمنينْ
فأنا لا أنا
وأنا كلّ ما قاله الشعراءُ على الحالتينْ
أيها الشعراءْ
الغناء وريثُ الغناءْ 9/2/2025